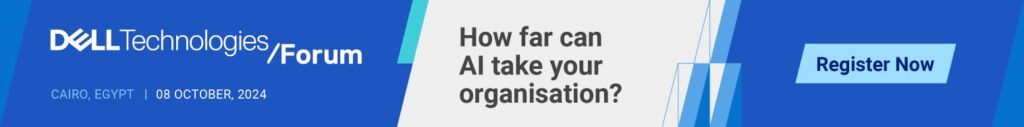في بلادِ اللهِ ، آلافُ المساجدِ ، كلٌّ منها يحملُ اسماً يخصُه ، ويدلُ علي الرسالةِ المرجوةِ منه ، فهَذَا ( التقوي ) وذاكَ (الإيمانُ ) وثالثُهم ( الرحمةُ ) وغيرُ ذلكَ .
وكثيراً ما تتشابهُ الأسماءُ ، وقليلاً تختلفُ ، لكنَّها ، وفي كُلِّ الأحوالِ ، تسيرُ في نَسقٍ واحدٍ ، وهو الإيمانُ باللهِ تَعَاَلي ، إذ هو منهاجُ كُلِّ المساجدِ ، في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ .
( كأَنّي أَكَلْتُ ) ! لَيْسَ وصفاً لحالٍ ، بل اسمٌ لمسجدٍ ! نوعٌ غريبٌ من الأسماءِ .
كيفَ ذلكَ ؟ وما معني هَذَا الاسمِ العجيبِ؟! الذي يبتعدُ كثيراً عن توقعاتِ ومُراداتِ أسماءِ بيوتِ اللهِ .
وراءَ الأمرِ قصةٌ لا تخلو من الغرابةِ والإلهامِ .
تبدأُ قصةُ هَذَا المسجدِ العريقِ ، الذي بُني منذُ نحوِ أربعمائة عامٍ ، في العهدِ العثمانيِّ ، بأحدِ ضواحي إسطنبول ، على يدِ رجلٍ يُدعى (خيرَ الدِين كججي أفندي ) وكانَ الرجلُ حقاً وصدقاً ، خيراً للدِين .
يُحكى أنَّ هَذَا الأخيرَ ، كانَ يمشي بالأسواقِ ، ويرى الأطايبَ من الطعامِ والشرابِ أمامَه ، مستشعراً الرغبةَ فيها ، والضعفَ أمامَها ، شأنُه شأنُ الناسِ جميعاً ، لكنَّ خيرَ الدِين ، كانَ له رأيٌّ آخرُ ! فلم يسعَ لإرضاءِ شهواتِ نفسِه ، بل كانَ يضعُ ثمنَ ما اشتهاه في صندوقٍ ، يحتفظُ به في بيتِه ، مواسياً نفسَه ، ومحاولاً إقناعَها ، بأنَّه نالَ ما اشتهي ، مردداً : كأَنّي أَكَلْتُ !
تمرُ الأيامُ ، وتتوالي السنون ، ويُصبحُ الصندوقُ قادراً علي بناءِ مسجدٍ متواضعٍ ؛ لتتحققَ بذلكَ الأمنيةُ التي طالَ انتظارُها ، وجمعَ كُلَّ هَذَا المالِ لأجلِها ، ومن أجلِها أيضاً ، كانَ حرمانُه !
المسجدُ شديدُ البساطةِ ، مساحتُه تزيدُ قليلاً عن مائةِ مترٍ مربعٍ ، لا يتسعُ إلا لمأتي مُصلٍ بالكادِ ، وصُمِمَ في بدايتِه ، بدونِ أسقف ! وبأسوارَ منخفضةٍ !
لم يكنْ خيرُ الدِينِ صحابياً ، ولا تابعياً ، كانَ فقيراً ، كما لم يكنْ مُطالَباً بهَذَا العملِ ، بمفردِه .
لم يكنْ حُلُمُه بناءَ بيتٍ لنفسِه ، بل بناءَ بيتٍ للهِ ، يُذكرُ فيه اسمُه .
كانَ الرجلُ تقياً نقياً زاهداً ورعاً ، آثرَ الآخرةَ علي الدُنيا ، تحوي ضلوعُه قلباً ، تغلغلَ الإيمانُ في أعماقِه .
ما هَذَا يا جابر ؟ هكذا سألَه أميرُ المؤمنين ، عمرُ ابْنُ الْخَطَّابِ ، رضي اللهُ عنه وأرضاه ، لما رأي لحماً مُعلقاً بيديِّه ، فأجابَ : اشتهيتُ لحماً فاشتريتُه . فقالَ : أو كلما اشتهيتَ اشتريتَ ، يا جابر ! أما تخافُ هَذِهِ الآيةَ : اَذْهَبتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا .
مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ وهكذا سألَه رسولُ اللهِ ، صلي اللهُ عليه وسلمَ ، قلتُ : يا نبيَّ اللهِ ، وما ليَّ لا أبكي ، وهَذَا الحصيرُ قد أثرَ في جنبِك ! وذاكَ قيصرُ وكسرى في الثمارِ والأنهارِ ، فقالَ ( ص ) : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا ؟ قلتُ : بلى يا رسولَ اللهِ .
خيرُ الدِين ، عاشَ فقيراً ، وماتَ كذلكَ ، فارقَ الدُنيا وبقي أثرُه فيها ، أثرٌ سطرَه التاريخُ إلي الآن ، وكتبَه بأحرفٍ من نورٍ ، فوقَ صحائفَ من ذهبٍ .
وفي حياتِنا أقوامٌ ، أغدقَ اللهُ عليهم من النِعَمِ ، ما لا تُصدقُه العُقولُ ، فكانَ سعيُّهم في الدُنيا ، نحوَ قصورٍ منيفةٍ ، ومركباتٍ فارهةٍ ، ورَغَدٍ من العَيشِ !
هل بنوا مدرسةً ؟ لا
هل داووا مريضاً ؟ لا
هل أغاثوا ملهوفاً ؟ لا
هل أعانوا أرملةً ؟ لا .
هؤلاءِ أحياءٌ فعلاً ، بحُكم الشهيقِ والزفيرِ ، لكنَّهم أمواتٌ حقاً ، بحُكمِ الهدفِ والغايةِ .
قد ماتَ قومٌ وما ماتَتْ فضائلُهم .. وعاشَ قومٌ وهُم في الناسِ أمواتٌ..